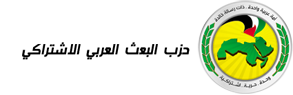فراس عزيز ديب..
عندما يقرر رجل الدين العمل في السياسة فهو أمام أحد أمرين: إما أن يخلَع هذا الثوب فيجعلنَا نرد عليهِ في السياسة، أو أن يحترمَ هذا الثوب، ويلتزمَ روحيةَ ما تدعو إليه جميع الأديان من احترامٍ للإنسانية وقول الحق، فلا يمكن لك أن تكونَ رجلَ دين وتعمل في السياسة، وبذات الوقت لا يمكن لك أن تكون سياسياً وتدّعي أنك تحاول تطبيق أمر الله، فادعاء الموازنة بين الماديات والروحانيات هو تماماً كادعاء الموازنة في الجمع بين أكثر من زوجة، كلاهما باطل.
غالباً هناك من لا يزال يعتقد أن فكرة خنق الدين بالسياسة هو حكر على «الإسلام السياسي» فقط، وبالكاد تحاول أن تطرح فكرتك بأن «الدعشنة الفكرية» هي نمط حياةٍ إقصائي يتقنهُ حتى من يدّعون الإلحاد، يخرجون عليك بنظريات «ياغيرة الدين». هؤلاء يتجاهلونَ مثلاً فرضية أن هناكَ إسلاماً سياسياً ارتكبَ ما ارتكبهُ من مجازرَ في سورية والجزائر، وهناك مسيحية سياسية ارتكبت ما ارتكبته من مجازرَ في لبنان وأوروبا زمن سلطة الكنيسة، حتى جورج بوش ذاتَ نفسه تحدث عن مصطلح «عودة الحروب الصليبية» خلال غزو العراق، أما اليهودية السياسية فحدث ولا حرج.
جميعَ هؤلاءِ المتاجرينَ وصلوا اليوم لنقطة ما كلٌّ منهم يكمِّل الآخر، والجميع مستفيد من الجميع، ألم تستفد اليهودية السياسية والمسيحية السياسية من الإسلام السياسي بتدميرِ دولٍ بحالها، ألم تستفد اليهودية السياسية من المسيحية السياسية بإعطائِها صكّ براءةٍ عن كل الجرائم التي ارتكبتها، حتى المسيحية السياسية جندت كل ما بإمكانه أن يجعلها تستفيد من الإسلام السياسي! لندقق مثلاً بأرقام المهاجرين المسيحيين من العراق وسورية، ألم تقم الكنيسة ذات نفسها بالإشراف على تسهيلِ وهجرةِ هؤلاء، هل يعلم البعض أن في فرنسا قانوناً خاصاً للهجرة المسيحية متعلق بمسيحيي العراق عدَّولوه اليوم ليضمَّ مسيحيي سورية والكذبة الكبرى جاهزة: إن جرائمَ الإسلام السياسي تتسبب بتهجيرَ المسيحيين، لكن أين تقفون أنتم من هذا الإسلام السياسي؟
عندما بدأت قوات الجيش العربي السوري في شباط الماضي معركةَ تحرير الغوطة من رجسِ التنظيماتِ الإرهابية، خرج علينا بابا الفاتيكان بخطابٍ يقول فيه إن «سورية تَستشهد»، اللافت يومها أن البابا كان يُخاطب زوارهُ في ساحةِ القديس بطرس، وربما لم يستطع أحد أن يُلقي على مسامعهِ عبارةَ أنك تتحدث من ساحةٍ تحمل اسم قديسٍ سوري يعود نسبهُ إلى جنوب بحيرة طبرية، أي إن سورية التي ظنَّها يوماً أنها ستستشهد كانت ولا تزال قائمة منذ ما قبل أن يُخلق القديس بطرس، ومنذ ما قبل أن تنخرط الكنيسة بفتاوىٍ باباوية في حرب المئة عام الطائفية، أو جرائم ملوك فرنسا ومن بينهم شارلمان، الأدق يا قداسة البابا أن سورية تُصلب لكنها ستقوم لأنها أساسُ القيامة، ومن قال إن القيامةَ حكرٌ فقط على الأنبياء؟!
بعد صمتٍ استمر شهور، عاد قداسة البابا وتذكر سورية من جديد ليتحدث عن المدنيين «الأبرياء» وإراقةِ الدماء في إدلب، ويا للصدفة أنه لا يتذكرها إلا عندما يعلن الجيش العربي السوري نيتهُ تحريرَ منطقةٍ ما من رجسِ الإرهاب، وكأنه كما باقي جوقةِ المتباكين في «الغرب الحضاري» يظن أنه أحرص على السوريين من القيادة السورية، ألهذا الحد باتت معركةَ تحرير إدلب كابوساً تدفعهم لإخراج جميع أسلحتهم الإعلامية؟
لكن الرد العملي على تصريحاتِ البابا جاءَت هذه المرة من المجرمين الذين يريد حمايتهم، فدفعت مدينة محردة الوادعة الثمن عبر صواريخ الحقد التي طالتها من أولئك «الأبرياء».
عائلةٌ بكامِلها ارتقت، تُرى هل يريد قداسته أن يقنعنا بأن من ضربنا صاروخاً على خدِّنا الأيمن سنُدير له الأيسر، ماذا سنقول لدماء الأطفال فادي وماريا ولمى ووالدتهم؟ هل سنقول لهم عذراً لأن الإنسانية باتت سلاحاً انتقائياً نستخدمه متى يشاء ذاك «الغرب الحضاري»؟ ماذا لو صرخت دماؤهم البريئة وهي تقول لكل المدافعين عن أولئك الإرهابيين: تباً لكم ولأبريائِكم، عندها سنعتذر منهم ونقول لهم لا تلعنوا الإسلام السياسي الذي قتلكم بل العنوا من استخدمهُ ذريعةً ليدفعكم للهجرة، العنوا من يعطي صك الغفران لقاتليكم، العنوا ذاك الحضيض الذي أوصلَ كل من يستثمر الدين في السياسة ليغتالَ براءتكم، عندها سيكون الرد المنطقي على ما يريده قداسة البابا هي مقولة للبابا الأسبق يوحنا بولص الثاني:
«إن خطيئة عصرنا الكبرى هي موتُ الضمير، وعدمَ الإحساس بالخطيئة»
نتفِق مع هذهِ العبارة تماماً، لكنها حُكماً ستُصبح أكثر دقةً لو كانت:
إن خطيئة عصرنا الكبرى هي المتاجرة بالضمير، لأن التجارة بالضمير تجعل من القاتل حمامةَ سلام، وتجعل كل الدماء والدمار الذي تسببت بهِ نرجسيةَ أولئك الذين يظنون أن اللـه لم يهد سواهم مجرد نَسياً منسياً عند تلك الشعوب المترعة بالجهل والتبعية، ليصبح الاستثمار في الإسلام السياسي من كل تجار الأديان أشبه بالباعةِ الجوالين منتصف القرن الماضي، يحملونَ بضاعتهم على دابةٍ متجولينَ هنا وهناك، واليوم يبدو أن دابةَ هذا الاستثمار قررت العودة للعراق من جديد، فهل إن المغانم تغري بالعودة؟
عندما يتم طرحَ السؤال المنطقي: متى بدأ عملياً تعويم مصطلح الصراع «السني الشيعي» لتوصيف كل المشاكل في هذا الشرق البائس؟
هناك من يرى أن الأمر بدأَ مع خروج الولايات المتحدة إلى الحربِ على الإرهاب بعد أحداث أيلول 2001 وما تبعه من غزوٍ للعراق واحتلال، وهناك من يربط ذلك باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
ببساطة تبدو هذهِ الأحداث بعضَها متمِّمة، وبعضَها أرضية، لكن نقطة الانطلاق الحقيقية كانت عملياً هي اللحظة التي أصرَّ فيها الأميركي على أن ينشرَ فيديو إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، هناك من يظن واهماً أن قرار الإعدام صباحَ يوم عيد الأضحى وسط الأهازيجِ الطائفية كانَ قراراً عراقياً، لا يمكن لمن جاءَ على ظهرِ الدبابة الأميركية أن يقرِّر، من قرر يومها هو من كان يعي أهمية هذا الحدث، ومن استنكر يومها لم يستنكِر دفاعاً عن صدام، وإن كنا لم نر أي إثباتٍ لما تم اتهامهُ به، بل استنكر لأنه قرأ ببساطةٍ أن هذا الأسلوب سيُمعن في التفرقة والشرخ، وربما أن المدقق بِمسارِ الأحداث من اللحظة التي تلت هذا الإعدام حتى هذه اللحظة التي بات فيها المواطن في هذا الشرق البائس يريد الحرب مع إيران ولا يريدها ضد «إسرائيل»، يدرك تماماً أنهم نجحوا في مسعاهم.
منذ ذلك الوقت حاول عُقلاء العراق لملمةَ الأوضاع، لكن سيطرة رجالِ الدين في العراق على مفاصلِ الحياة السياسية هو سلاحٌ ذي حدين، وما يجري في العراق لا يبدو أن الهدفَ منه فقط إعادة خلط الأوراق في العراق نفسه، بل إنه عودة للأساس.
لنستثمر في الإسلام السياسي حتى آخرَ قطرةِ دمٍ في هذا الشرق البائس، فتصاعد الأحداث بات مقلقاً حتى للجار الإيراني نفسه، وهو الذي كانت مقراته أولى ضحاياها، وقد يكون تصاعدها وسيلةَ ضغطٍ قد تنعكس في الأيام القادمة على وجهةِ نظر إيران من معركةِ إدلب أو الهدنة فيها، كما أن استهداف الجنوب العراقي يعني عملياً نجاحاً أميركياً إسرائيلياً بقطع الطريق الواصل بين دمشق وطهران، ومن ثمّ إن ما يجري في العراق ليس مزحة، ولا يبدو ببساطة أنه قابلٌ للعلاج وسط الانقسام الحاصل، تحديداً أن الجرعات الطائفية والمذهبية تبدو في أوجها، وهو كان ولا يزال نتاجَ تراكماتٍ إخفاق العراقيين عبر السنوات التي تلت خروج المحتل بالتحررِ منها، تماماً كما هي التجربة اللبنانية، وأساساً لا يبدو أن من مصلحةِ المتاجرين بدماء الأبرياء أن تُغلق الفوضى في هذا الشرق البائس لأن الجميع ودون استثناء مستفيد.
في الخلاصة: إن سقوط الثوابت بات فعلياً بلا حدود، فلا حُراس الهياكل سَلِموا من ذلك، ولا حتى من صدعوا رؤوسنا بأنهم حُراس الإنسانية كانوا بحالٍ أفضل، القضية ليست فقط بدفاع المسيحية السياسية عن الإرهابيين ولا بتلاقيها مع اليهودية السياسية، فمن توقع مثلاً أن مسؤولاً أممياً على شاكلةِ المبعوث ستيفان دي ميستورا سيخرج يوماً ليدافعَ عن إرهابيين يحملونَ كل شيء إلا الشموع!
لكل ثوبٍ ديني كان أم غيرَ ديني هيكلهُ، هذا الهيكل سيبنيهِ على دماء الأبرياء لأنه ببساطة أرادَ أن يحقق ماديةً دنيوية بروحانيةٍ سمحة، قد يستطيع كل هؤلاء أن يتاجروا بهياكلهم لفترةٍ من الزمن لكنهم حكماً لن يفعلوا ذلك على طول الزمن، وبمعنى آخر:
في الروحانيات سنحب أعداءنا، لكن في الماديات دعني من روحانيتك الانتقائية لأننا في المعارك لا نؤمن إلا بشعارٍ واحد: عندما أرفع سيفي لكي أقاتل عليَّ ألا أفكر بمن سيموت، علي أن أفكر بمن سيعيش، ونقطة على السطر.
الوطن