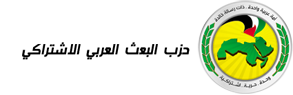عادت الدول العربية إلى بعضها بعد أحد عشر عاماً من العداء بتحريض من القوى الغربية، وبعد أشرس حرب بالوكالة شهدها العالم. اليوم تشارك سورية في القمة العربية المزمع عقدها في السعودية (19 أيار الجاري)، لتكون القمة “قمة سورية بامتياز” باعتراف كلّ الوفود العربية المشاركة في القمة، حيث حظي الوفد السوري الرسمي والإعلامي بترحيب كبير من قبل الأشقاء السعوديين والعرب.
وهذا يعني، بلغة السياسة، انتصار سورية التي لطالما نادت بضرورة التضامن العربي لمواجهة المخاطر الخارجية، وحملت راية القضايا العربية ودفعت ثمنها باهظاً، فلو كان العرب يداً واحدة لما هبّ “الربيع العربي” على المنطقة العربية، ولما تمادى الكيان الإسرائيلي في إجرامه وصهيونيته تجاه الشعب الفلسطيني.
وفي حين أن عودة سورية كانت حديث وسائل الإعلام العربية والإقليمية، مرحبة ومهلّلة بهذه العودة الحميدة، لم تستطع بعض الحكومات الغربية ووسائل إعلامها، وعلى رأسها الولايات المتحدة لجم غيظها وكيدها، فهي تكون في قمة السعادة عندما تزرع بذور الفتنة بين الأشقاء العرب. ولكن كل هذا لا يهمّ طالما أن قطار السلام في سورية والمنطقة العربية انطلق بخطا ثابتة، ولن يتوقف حتى يعمّ كافة أرجاء الوطن العربي، وكلّ المعطيات على الأرض تشهد أن ثمة “تسونامي الدبلوماسية” تجري الآن في الشرق الأوسط ستحرم الولايات المتحدة من إمكانية الاستمرار في سرقة النفط السوري.
من الواضح أن الأساس في كلّ هذا “الانقلاب” هو السعودية، التي بدأت بالتحول في الولاء على الأقل منذ ارتباط روسيا بمنظمة “أوبك +”، حين اتفقت روسيا والسعودية على مواجهة إنتاج الغاز الصخري الأمريكي قبل “حرب النفط” التي أعقبت جائحة كورونا. يبقى العامل الرئيسي المتمثل في صعود الصين، ففي أعقاب الاتفاق الذي توسّطت فيه الصين بين السعودية وإيران، بدأت ثورة دبلوماسية أخرى تختمر في الشرق الأوسط، وهذه المرة، روسيا هي التي تلعب دور قائد الفرق الموسيقية، في حين أن العالم لم يستوعب بعد حقيقة -عواقب- التقارب السعودي الإيراني الذي رعته الصين، فقد وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد، حيث جاءت زيارته في أعقاب زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد إلى الرياض الشهر الماضي.
بالمجمل يجب فهم الموقف الدبلوماسي السعودي في سياق تعريف جديد لسياستها الخارجية، وهو ما ينعكس في الاتفاقية التاريخية الموقعة مع إيران، إذ يسعى هذا النهج الجديد إلى الاستقرار الإقليمي من خلال حلّ النزاعات، وتصفير المشكلات، بدلاً من استراتيجيات الاحتواء العسكرية، وهذا ما دعا إليه الوزير السعودي في دمشق بالقول: “إن هدف السعوديين هو إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية لوضع حدّ لردود الفعل العكسية في المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة والاستقرار والهوية العربية لسورية، والسماح لها بالاندماج في بيئتها العربية”.
هذا التقدم الدبلوماسي الكبير بين الرياض ودمشق هو نتيجة لتزايد نفوذ روسيا في شؤون الشرق الأوسط، ويشكّل أحدث المؤشرات الواضحة لفقدان هيمنة الولايات المتحدة في المنطقة، حيث تتراجع بصمتها العسكرية والدبلوماسية بشكل مطرد في غضون السنوات الأخيرة. فخلال العام الماضي، شهدت الولايات المتحدة نفسها مهمّشة بشكل متزايد في غرب آسيا، بسبب عقود من التدخل العسكري والإكراه الاقتصادي، فيما قاد الحلفاء السابقون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الهجوم، وأقاموا علاقات تجارية وأمنية وثيقة مع روسيا والصين وإيران. بينما ملأت الصين، على وجه الخصوص الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من خلال التوسّط في انفراج تاريخي بين طهران والرياض، وهو الذي مهّد الطريق لمحادثات السلام الجارية في اليمن، وأنهت عزلة المنطقة، كما استعرضت روسيا قوتها الدبلوماسية لحلّ الأزمة السورية من خلال استضافة عدة اجتماعات رفيعة المستوى شارك فيها مسؤولون سوريون وأتراك يسعون لإنهاء احتلال أنقرة لشمال سورية.
هذا ويعوّل الشارع السوري الكثير الكثير على القمة العربية، وعلى عودة ترسخ التضامن بين الأشقاء مع بعضهم البعض، ويأمل برؤية النتائج على واقع حياته، ويعلق آمالاً عريضة على انفراج الوضع الاقتصادي السوري المتأزم بفعل الحرب التي دمّرت الحجر والبشر، وبفعل العقوبات الغربية الكيدية التي حرمته من مقومات الحياة الأساسية، ومن ثم بفعل الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في شهر شباط الماضي مخلفاً خسائر مادية كبيرة، والذي كان له الأثر في إبراز التضامن العربي بأبهى حلله، وكذلك التعاطف الأجنبي، حيث هبّ العالم تقريباً برمته لمساعدة الشعب السوري المنكوب في تحدّ كبير لكسر العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجائرة.